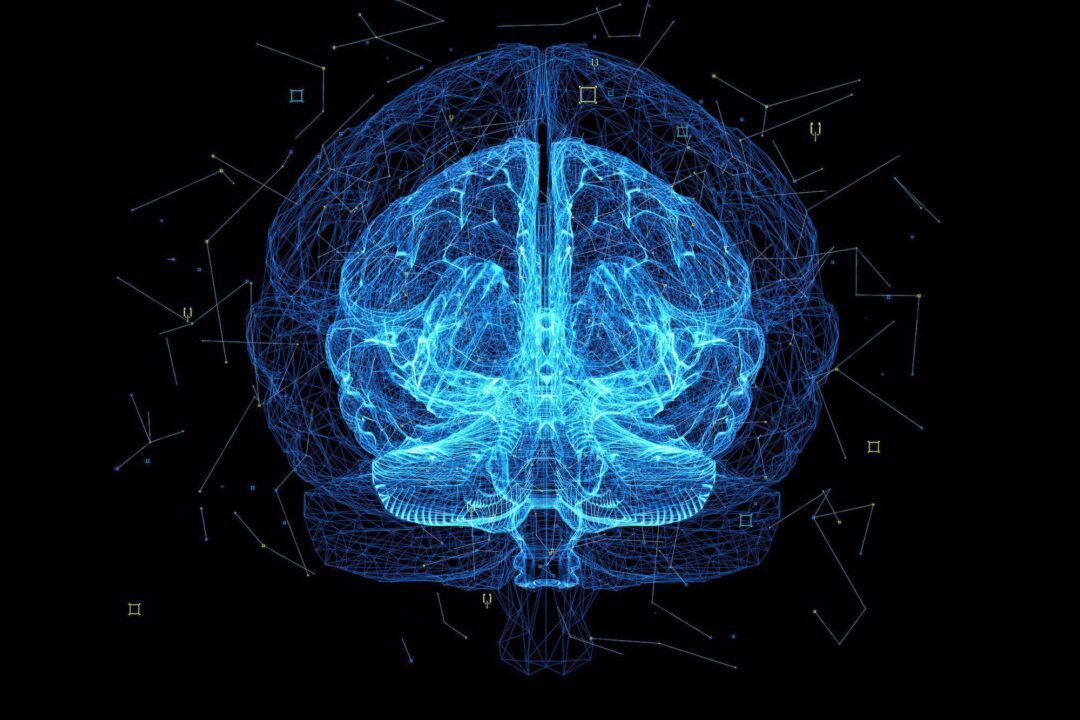لطالما كان خيالي واسعاً وجليا. عندما كنت طفلاً، كنت أطيل التحديق في راحة يدي متفحصا التشققات على جلدي لأشاهد العوالم الداخلية التي تعج بحياة أخرى غريبة. كنت أتخيّل حضارات كاملة، يعيش أفرادها أيامهم غير مدركين بأن واقعهم كله محفور في جزء صغير من جلدي وبأن كل ما كانوا يفعلون ساهم في تكوين الأنظمة التي أدت إلى وجودي أنا. بيد أنني لم أعرف حينها أن خيالي ذاك لم يكُن بعيداً جداً عن الحقيقة.
بالفعل، يوجد بداخل كل منا مزيج متناغم من الحياة، ولكنه أكثر تعقيداً وحيوية من كل ما استطعت تخيله. إننا مجموعة من الأنظمة الحيوية المترابطة المنسقة بعناية فائقة، والناشئة عن مزيج مكوّن من 20 حمضاً أمينياً يهتدي بالشكل اللولبي المزدوج لأربعة أحماض نووية، وتعطي هذه المجموعة من خلالنا معنى للوجود بأكمله.
هناك مقولة شهيرة لكارل ساغان يقول فيها «نحن مجرد طريقة يتعرف بها الكون على نفسه»، ولكنها تنطوي على مبالغة إلى حدٍ ما، فـ«نحن» برأيي نتاج آليات الحياة التي تم تعلمها، ونتاج عصور من التجربة والخطأ، حيث تقودنا كل خطوة عشوائية لتعزيز قدرتنا، وتمنحنا الصفات الضرورية لنكتشف ونتعلم المزيد حول ذواتنا وهذا الكون الذي نعيش فيه.
لطالما تساءلنا نحن عن الكيفية التي جئنا بها إلى هذا الوجود وسبب وجودنا، ويُعَّد هذا التساؤل بحد ذاته من الأمور التي نعرف أنها تميّزنا عن كل أنماط الحياة الأخرى. لم يقبل البعض منا بالقصص التي انتشرت في أزمانهم، فاستمر هؤلاء في البحث والتأمل في تلك الأسئلة إلى أن استطاعوا تطوير الأدوات التي حسّنت من قدرتنا على البحث في المجهول، فوسعوا مداركنا حول الوجود بأكمله.
ويتمثل الدرس الأساسي من كل ما تعلمناه في أن الحياة لا تتوقف أبداً عن التقدم. إنها عملية مستمرة من التطوير الذاتي المدفوع بمتغيرات لا تُعَّد ولا تُحصى وتغيرات خفيّة في تركيبتنا الجينية. في معظم الأوقات، لا يكون لهذه التغييرات أثر يُذكر، ولكنها تمنحنا أحياناً ميزات إضافية.
وبين الحين والآخر، تؤدي هذه التغييرات إلى خسائر قاسية للغاية نتكبدها نحن.
ها قد مرت عشر سنوات على بداية ظهور الأعراض لدي. ولربما مرت 20 سنة أو أكثر منذ أن بدأ الخلل في جسدي. إنني ممتن لأن هذا التدهور كان تدريجياً، ولكنني أدرك أكثر فأكثر كل يوم إصراره على الاستمرار. في هذه الأيام، من النادر أن تمر لحظة واحدة دون أن أشعر بآثار المرض على كل ما أقوم به، بما في ذلك طباعة هذه الكلمات التي تقرؤونها الآن.
كتبت الكثير من كلمات هذه المدونة إما وأنا أحاول أن أجبر ذراعيّ وأصابعي المتصلبة والبطيئة على الحركة بسرعة تكفي لطباعة ما أنوي كتابته، وإما وأنا أحاول مقاومة الرعشة غير المنتظمة في ذراعي اليمنى ورجلي الناتجة عن اضطراب «خلل الحركة». يخيفني أن أفكر في صعوبة هذا الأمر بعد مرور عشر سنوات من اليوم، ولكن لا فائدة تُرجى من التفكير في المستقبل، فكل لحظة حالية تتطلب الكثير، وهناك الكثير ممّا ينبغي فعله.
بفضل الحكمة التي انتقلت إلينا من أجيال لا تُعَّد ولا تُحصى من المفكرين الذين لم يرضوا بالقليل، نحن أقرب اليوم من أي وقتٍ مضى إلى العثور على إجابات للأسئلة التي تحيرنا حول الخلل الذي يحدث بداخلنا. وعلى الرغم من وجود فجوة واسعة بين ما نعرفه وما نحتاج إلى معرفته، إلا أن هناك سبباً وجيهاً للإيمان بأن التقدم الذي نحرزه سوف يقودنا إلى اكتشافات مهمة تُفسّر لنا سبب تدهور أنظمتنا وتعطينا الأدوات اللازمة للتدخل المناسب.
هناك إرشادات هامة للوصول إلى هذا الهدف، وهي مدفونة في مخططات الآلة المجهرية الجزيئية التي تجعلنا على النحو الذي نحن عليه، وأقصد الجينوم الخاص بنا. على مدار الفترة الأطول من تاريخنا، انتقل فهمنا للحياة من جيل إلى آخر بواسطة القصص التي ألّفناها ومرّرناها إلى الأجيال اللاحقة شفهياً في بداية الأمر ومن ثم بواسطة التقاليد المكتوبة. بيد أنه وفي العقود القليلة الأخيرة، اكتشفنا أن المسجّل المثبت في أعماق كل منا أكثر قوةً ومعرفةً بالحياة من أي شيء كتبناه.
ابتداءً من جينات «HOX» التي تتحكم بنمونا، وبتوقيت وكيفية نمو كل خلية، وجين ARC الذي انتقل إلينا من تفاعل سابق مع الحمض النووي الريبوزي الفيروسي، والذي يبدو أنه أساسي لمنحنا القدرة على تكوين الذكريات، وصولاً إلى الانتقال الأفقي للمادة الجينية بين خلايانا والكميات الهائلة من المجهريات بداخلنا، تساعدنا هذه القدرة المكتشفة حديثاً لفك الشيفرة الجينية على فهم من نكون بالفعل وتعطينا أهدافاً جديدة يمكننا الوصول إليها في معركتنا الطويلة ضد المرض في آنٍ واحد.
ولكن عندما يتعلق الأمر بتدهور دماغ الإنسان، لم تثبت المعلومات الجينية التي اكتشفناها فائدتها بعد، فأفضل ما يمكننا فعله اليوم هو أن نخبر المرضى بأن لديهم جين «س» وأنه مرتبط بالمرض «ص»، ولكن في ظل محدودية قدرتنا على الخوض في اختبارات تجريبية، إن توفرت هذه بالأساس، فلا يوجد ما يمكن للمرضى أو الأطباء فعله بهذه المعلومات، أو على الأقل ليس بعد.
وبين الحين والآخر، أطلب من علماء الأحياء الذين أعرفهم أن يغمضوا أعينهم ليتخيلوا ما يحدث لخلية واحدة فقط من أصل 37 تريليون خلية تؤلف معاً كينونتنا. ومثلما فعلت الآنسة «فريزل» عندما كانت تقود طلبتها في رحلة في قصة «باص المدرسة السحري»، أطلب منهم أن يأخذوني في جولة لأرى ما يرون. يتضح لنا بسرعة إلى أي حد تُعَّد الصورة التي يشكلونها غير مكتملة، وإلى أي حد نلجأ إلى القصص لنملأ الفجوة ونعبّر عمّا نعتقد أننا نعرفه. على الرغم من ذلك، أشعر بالامتنان لأن التقدم يحدث سريعاً اليوم.
أتذكر اللحظة التي بدأت ألاحظ فيها أن أمراً ما لا يسير على ما يُرام بداخلي قبل عشر سنوات، وأقارن تلك اللحظة بكل ما تعلمناه منذ ذلك الحين حول الفسيفسائية الجينية mosaicism، والتخلّق الجيني epigenetics، والتحوّلات البروتينية post translational modifications، وتعدد النمط الظاهري للجينات pleiotropy والقشوة epistasis وغيرها الكثير. بفضل هذه المعرفة، نستطيع تحويل ما كان يوماً عصياً على الفهم إلى موضوع يمكننا البدء باستيعابه، ولعب دور هام في معركتنا الجماعية ضد المرض في الوقت ذاته.
ما الذي سنتعلمه من دراسة تسلسل 150 ألف شخص مصاب بداء باركنسون؟ ما الدروس الجديدة التي سنتعلمها حول الخلل في كل فرد؟ ما عدد الأمراض التي سيصبح بالإمكان مداواتها؟ إن جزءاً من جمال كل ذلك، تماماً مثل أي محاولة لكشف المجهول، هو أننا لا نعلم بعد. ندرك بأن الجينات لوحدها لن تكون كافية لإيصالنا إلى الهدف الذي نطمح إليه، ولكنها سوف تشكل أرضية للمعرفة التي ستنطلق منها المقاربات العلاجية الجديدة. وأثناء المسير نحو هذا الهدف، سوف تساعدنا هذه المعرفة على العثور على التفاصيل التي فاتتنا عن الحياة وكل ما يحدث في تلك التشققات في جلدنا.